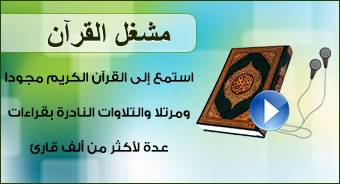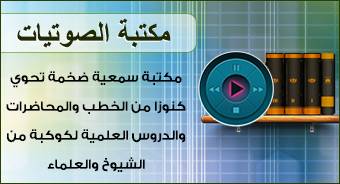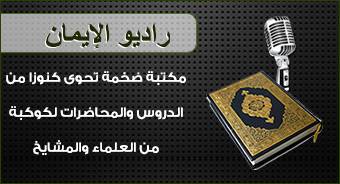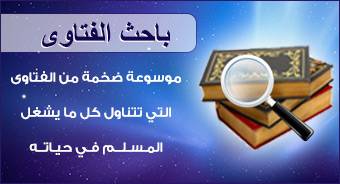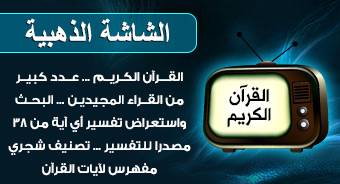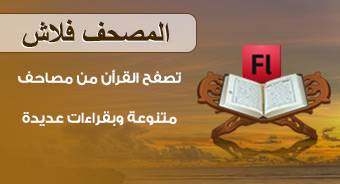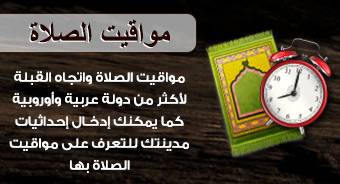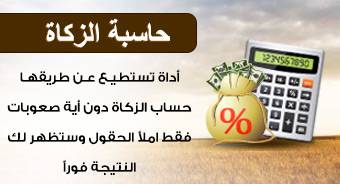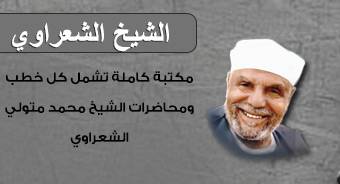|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وإنما قال: {والعاملين عَلَيْهَا} لأن كلمة على تفيد الولاية كما يقال فلان على بلد كذا إذا كان واليًا عليه.الصنف الرابع: قوله تعالى: {والمؤلفة قُلُوبُهُمْ} قال ابن عباس: هم قوم أشراف من الأحياء أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلًا، أبو سفيان، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وحويطب بن عبد العزى، وسهل بن عمرو من بني عامر، والحرث بن هشام، وسهيل بن عمرو الجهني، وأبو السنابل، وحكيم بن حزام.ومالك بن عوف، وصفوان بن أمية، وعبد الرحمن بن يربوع، والجد بن قيس، وعمرو بن مرداس.والعلاء بن الحرث أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم مائة من الإبل ورغبهم في الإسلام، إلا عبد الرحمن بن يربوع أعطاه خمسين من الإبل وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الإبل، فقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أحدًا من الناس أحق بعطائك مني فزاده عشرة، ثم سأله فزاده عشرة، وهكذا حتى بلغ مائة، ثم قال حكيم: يا رسول الله أعطيتك الأولى التي رغبت عنها خير أم هذه التي قنعت بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل التي رغبت عنها» فقال: والله لا آخذ غيرها: فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش مالًا وشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العطايا لكن ألفهم بذلك.قال المصنف رحمه الله: هذه العطايا إنما كانت يوم حنين ولا تعلق لها بالصدقات، ولا أدري لأي سبب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذه القصة في تفسير هذه الآية، ولعل المراد بيان أنه لا يمتنع في الجملة صرف الأموال إلى المؤلفة، فأما أن يجعل ذلك تفسيرًا لصرف الزكاة إليهم فلا يليق بابن عباس، ونقل القفال أن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة، وقال المقصود أن يستعين الإمام بهم على استخراج الصدقات من الملاك.قال الواحدي: إن الله تعالى أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين، فإن رأى الإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شيء من زكوات الأموال إلى المشركين، فأما المؤلفة من المشركين فإنما يعطون من مال الفيء لا من الصدقات وأقول إن قول الواحدي إن الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام دفع قسمًا من الزكاة إليهم لكنا بينا أن هذا لم يحصل ألبتة، وأيضًا فليس في الآية ما يدل على كون المؤلفة مشركين بل قال: {والمؤلفة قُلُوبُهُمْ} وهذا عام في المسلم وغيره، والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ وأن للإمام أن يتألف قومًا على هذا الوصف ويدفع إليهم سهم المؤلفة لأنه لا دليل على نسخه ألبتة.الصنف الخامس: قوله: {وَفِي الرقاب} قال الزجاج: وفيه محذوف، والتقدير: وفي فك الرقاب وقد مضى الاستقصاء في تفسيره في سورة البقرة في قوله: {والسائلين وَفِي الرقاب} [البقرة: 177] ثم في تفسير الرقاب أقوال:القول الأول: إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، والليث بن سعد، واحتجوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قوله: {وَفِي الرقاب} يريد المكاتب وتأكد هذا بقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33].والقول الثاني: وهو مذهب مالك وأحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري به عبيد فيعتقون.والقول الثالث: قول أبي حنيفة وأصحابه وقول سعيد بن جبير والنخعي، أنه لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكنه يعطي منها في رقبة ويعان بها مكاتب لأن قوله: {وَفِي الرقاب} يقتضي أن يكون له فيه مدخل وذلك ينافي كونه تامًا فيه.والقول الرابع: قول الزهري: قال سهم الرقاب نصفان، نصف للمكاتبين من المسلمين، ونصف يشتري به رقاب ممن صلوا وصاموا، وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة، قال أصحابنا: والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب، والدليل عليه أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله: {إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاء} ولما ذكر الرقاب أبدل حرف اللام بحرف في فقال: {وَفِي الرقاب} فلابد لهذا الفرق من فائدة، وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاؤوا وأما {فِى الرقاب} فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق، ولا يدفع إليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤوا، بل يوضع في الرقاب بأن يؤدي عنهم، وكذا القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونهم، وفي الغزاة يصرف المال إلى إعداد ما يحتاجون إليه في الغزو وابن السبيل كذلك.والحاصل: أن في الأصناف الأربعة الأول، يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاؤوا، وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم، بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة.الصنف السادس: قوله تعالى: {والغارمين} قال الزجاج: أصل الغرم في اللغة لزوم ما يشق والغرام العذاب اللازم، وسمي العشق غرامًا لكونه أمرًا شاقًا ولازمًا، ومنه: فلان مغرم بالنساء إذا كان مولعًا بهن، وسمي الدين غرامًا لكونه شاقًا على الإنسان ولازمًا له، فالمراد بالغارمين المديونون، ونقول: الدين إن حصل بسبب معصية لا يدخل في الآية، لأن المقصود من صرف المال المذكور في الآية الإعانة، والمعصية لا تستوجب الإعانة، وإن حصل لا بسبب معصية فهو قسمان: دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة، ودين حصل بسبب حمالات وإصلاح ذات بين، والكل داخل في الآية، وروى الأصم في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالغرة في الجنين، قال العاقلة: لا نملك الغرة يا رسول الله قال لحمد بن مالك بن النابغة: «أعنهم بغرة من صدقاتهم» وكان حمد على الصدقة يومئذ.الصنف السابع: قوله تعالى: {وَفِى سَبِيلِ الله} قال المفسرون: يعني الغزاة.قال الشافعي رحمه الله: يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيًا وهو مذهب مالك وإسحق وأبي عبيد.وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله: لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجًا.واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: {وَفِى سَبِيلِ الله} لا يوجب القصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله: {وَفِى سَبِيلِ الله} عام في الكل.والصنف الثامن: ابن السبيل قال الشافعي رحمه الله: ابن السبيل المستحق للصدقة وهو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة.قال الأصحاب: ومن أنشأ السفر من بلده لحاجة، جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل، فهذا هو الكلام في شرح هذه الأصناف الثمانية.
والمسكين الذي لا شيء له، بدليل قول الله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16] يعني: الذي لم يكن بينه وبين التراب شيء يقيه منه؛ وقال بعضهم: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له أدنى شيء.كما قال الله تعالى: {أَمَّا السفينة فَكَانَتْ لمساكين يَعْمَلُونَ في البحر فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} [الكهف: 79] سماهم مساكين، وإن لهم سفينة، وقال بعضهم: الفقير الذي لا يسأل الناس إلحافًا، كما قال الله تعالى: {لِلْفُقَرَاء الذين أُحصِرُواْ في سَبِيلِ الله} إلى قوله: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى} [البقرة: 273] والمسكين الذي يسأل الناس.
|