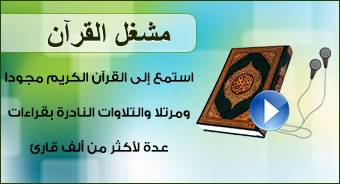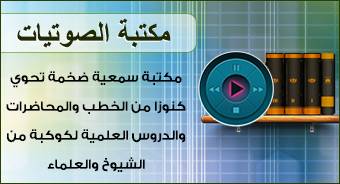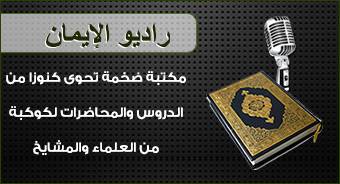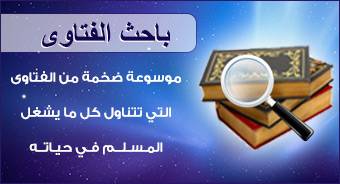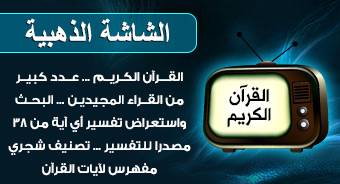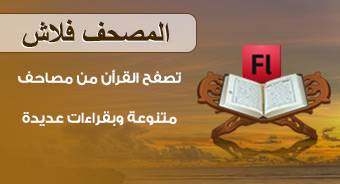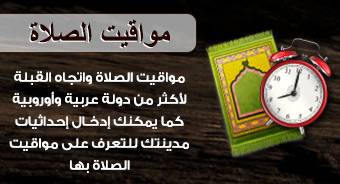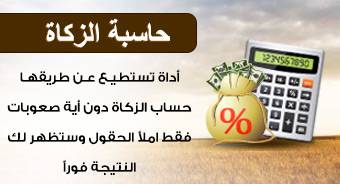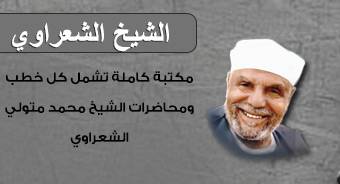|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[الموسوعة الفقهية 30/ 334].
[الموسوعة الفقهية 30/ 337].
وقوله تعالى: {إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ} [سورة الفجر: الآية 7]: أي ذات الأبنية العالية الرفيعة، والعماد: جمع عمادة، كما في (القاموس المحيط)، و(المختار)، و(المصباح). وعمد إلى كذا يعمد- من باب ضرب- عمدا-: قصده، ويعمد الأمر بالتضعيف: قصده وعقد العزم عليه، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [سورة النساء: الآية 93]: أي قاصدا. وقال الله تعالى: {وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب: الآية 5]: أي ما قصدته قلوبكم وأصرّت عليه من الأيمان المعقدة التي عقدت عليها العزم. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 35].
واصطلاحا: إحاطة الأفراد دفعة، أو: القول المشتمل على شيئين فصاعدا. فائدة: اطراد العرف أو العادة غير عمومهما، فإن العموم مرتبط بالمكان والمجال، فالعرف العام على هذا: ما كان شائعا في البلدان، والخاص: ما كان في بلد أو بلدان معينة، أو عند طائفة خاصة. - وتظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة بين المطلق والعام، فالمطلق يشابه العام من حيث الشيوع حتى ظنّ أنه عام. ولكن هناك فرقا بين العام والمطلق: فالعام: عمومه شمولى، وعموم المطلق بدلى، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة. والفرق بينهما: أن العموم الشمولي كلى يحكم فيه على كل فرد فرد، وعموم البدل كلى من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد دفعة. وفي (تهذيب الفروق)- نقلا عن الأنبانى-: عموم العام شمولى بخلاف عموم المطلق، نحو: رجل، وأسد، وإنسان، فإنه بدلى حتى إذا دخلت عليه أداة النفي أو (أل) الاستغراقية صار عاما. وفي (أحكام الفصول): العموم: استغراق الجنس. عموم البلوى: يطلق الفقهاء مصطلح (عموم البلوى) ويعنون به: ما يعسر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو المحظورات. [إحكام الفصول ص 48، والأشباه والنظائر ص 83، والموسوعة الفقهية 5/ 113، 163، 31/ 5، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 251].
فالعناق: هي الأنثى من ولد المعز على ما ذكر، ما لم تجذع. والعقال- بكسر العين وفتح القاف-، قال أبو عبيد: هو صدقة عام، وقيل: أراد به الحبل الذي تعقل به الفريضة التي تؤخذ في الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها. [المغني لابن باطيش ص 199، 273، والمطلع ص 182].
أحدها: أنها من عنّ الشيء يعنّ ويعنّ- بكسر العين وضمها-: إذا عرض، كأنه عنّ لهما هذا المال: أي عرض فاشتركا فيه، قاله الفراء، وابن قتيبة وغيرهما. والثاني: أن العنان: مصدر: (عانة عنا ومعانة): إذا عارضه، فكل واحد منهما عارض الآخر بمثل ماله وعمله. والثالث: أنها شبهت في تساويهما في المال والبدن بالفارسين إذا سوّيا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء. والعنان في اللغة: السير الذي يمسك به اللجام. [المطلع ص 260].
وقيل: إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه، وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن: أنه نبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر. وقيل: هو شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل. وقيل: يخرج من عين، قاله ابن سينا، وقال: وما يحكى أنه روث دابة أو قيئها أو من زبد البحر فبعيد. [من شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 103، والمطلع ص 172].
وأعنته: أوقعه في العنت وشق عليه، قال الله تعالى: {وَلَوْ شاءَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [سورة البقرة: الآية 220]: أي كلفكم الأمور الشاقة التي توقعكم في العنت. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 39، المطلع ص 45].
حضرة الشيء، وهي ظرف زمان ومكان. تقول: عند الليل وعند الحائط، قال الجوهري: ولم يدخلوا عليها من حروف الجر سوى (من)، يقال: (من عنده)، ولا يقال: (مضيت إلى عنده). [تحرير التنبيه ص 37].
[المطلع ص 180].
الزج الحديدة التي في أسفل الرمح. وقيل: هي عصا صغير. [الكفاية 1/ 355، ونيل الأوطار 1/ 99].
- وقيل: شعيرات بين الشفة السفلى والذقن. - وقيل: العنفقة: ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى كان عليها شعر أو لم يكن. - وقيل: العنفقة: ما نبت على الشفة السفلى من الشعر. [لسان العرب (عفق)، والموسوعة الفقهية 25/ 317].
أعناق، والجماعة من الناس والرؤساء. [المصباح المنير (عنق) 432 (علمية)، ونيل الإطار 5/ 163].
وقيل: صغر الذكر جدّا ذكره في (الكواكب الدرية). وقيل: عجز الرجل عن إتيان النساء، وقد يكون عنينا عن امرأة دون أخرى. [المصباح المنير (عنن)، والكواكب الدرية ص 203، والإقناع 3/ 45].
قال في (المصباح): والفقهاء يقولون: به عنّة، وفي كلام الجوهري: رجل عنّين: لا يشتهي النساء من العنّة، وامرأة عنينة: لا تشتهي الرجال، فعيل، بمعنى: مفعول كجريح. وقيل: هو الذي له ذكر لا ينتشر. وقيل: هو الذي له مثل الزرّ، وهو الحصور. وقيل: هو الذي لا ماء له. والعنّة- بالضم-: العجز عن الجماع،- وبالفتح-: المرة من عنّ الرجل إذا صار عنينا، أو مجبوبا،- وبالكسر-: الهيئة من ذلك ومن غيره.- وجاء في (الفتاوى الهندية): هو الذي لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة، فإن كان يصل إلى الثيب دون الأبكار أو إلى بعض النساء دون البعض وذلك لمرض به أو لضعف في خلقه أو لكبر سنة أو سحر، فهو عنين في حق من لا يصل إليها. كذا في (البحر الرائق). - قال ابن عرفة: حاصل نقل عياض والباجي: أن العنين ذو ذكر لا يمكن به جماع لشدة صغره أو لدوام استرخائه. وروى الباجي عن ابن حبيب: العنين ما لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط. - جاء في (التوقيف): العنين- بالكسر-: من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر. - جاء في (المطلع): العنين: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه. - وجاء في (معجم المغني): العنين: العاجز عن الإيلاج. [المطلع ص 319، والفتاوى الهندية 1/ 522، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 253، والتوقيف ص 529، ومعجم المغني 7/ 602 7/ 152].
[معلمة الفقه المالكي ص 275]. |